المغرب في عصر الأزمة العالمية متعددة الأوجه.. “الإبحار في المجهول ومحاولة صياغة المصير”
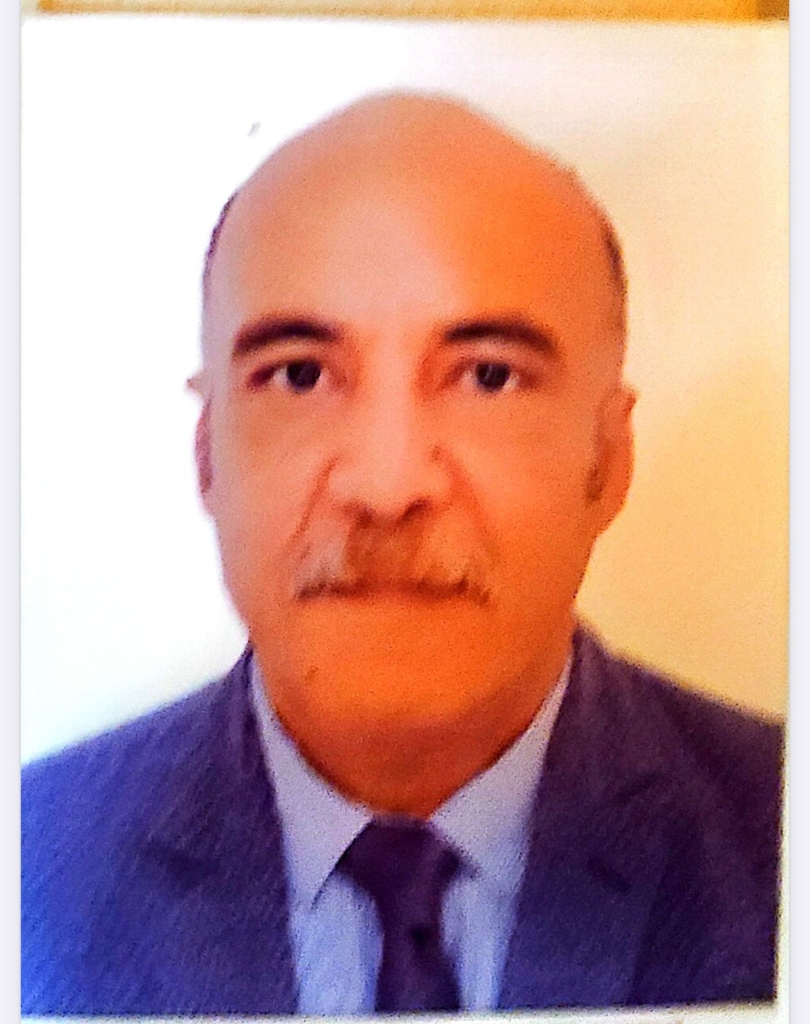
افتتحت سنة 2025 فصلاً جديداً من توتر عالمي غير المسبوق في القرن الواحد والعشرين، حيث لم تعد الأزمات المتتالية مجرد حوادث معزولة، بل تحولت إلى حالة مألوفة من طرف مؤسسات النظام الدولي وسكان الأرض. فمن رماد الحرب المباشرة بين إيران وإسرائيل، إلى حافة الهاوية النووية التي وصل إليها النزاع الهندي–الباكستاني، مروراً بالضربات الإسرائيلية التي استهدفت قلب الدوحة، والحروب المستعرة التي لا تزال تلتهم أوكرانيا، وتفكك السودان، و انهيار النظام السوري، و استباحة الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى الانهيار السياسي الذي أغرق نيبال في العنف، يبدو أن قواعد النظام الموروث عن ما بعد الحرب العالمية الثانية قد تحطمت بالكامل.
من ناحية أخرى، يواجه المغرب محيطًا مباشرًا معقدًا يشكل محددًا رئيسيًا لمساره الاستراتيجي. فالشرق محكوم بتوتر دائم مع الجزائر يغذي سباق تسلح ويعرقل الاندماج المغاربي، ولا يلوح في الأفق أي أمل لعودة العلاقات الطبيعية في ظل “الماروكوفوبيا” أو العداء اللامشروط للمغرب الذي جعلت منه الطغمة العسكرية الحاكمة “طوطما” سرمديا. أما الجنوب، فيظل مرتبطا بموريتانيا التي لم تستطع إلى حد الآن التخلص من عقدة “شنقيط”، في حين يشكل الساحل مجالا تهدده الانقلابات والتطرف، مما ينعكس على استقرار منطقة شمال إفريقيا بأكملها. أما الشمال، فتتجسد المفارقة في العلاقة مع إسبانيا التي تظل الشريك الاقتصادي والأمني الذي لا غنى عنه، لكنه مشوب بملفات خلافية كالهجرة وسبتة ومليلية والحدود البحرية، فضلا عن عقدة الأندلس التي مازالت تلقي بظلالها على شعب المملكة الإبيرية. وكل هذا يجعل المحيط المباشر للمغرب فضاءً مهيكِلاً يفرض توازنًا دقيقًا بين التعاون والردع ثم الحيطة و الحذر.
في هذا السياق المضطرب، يتبلور مفهوم “الأزمة متعددة الأوجه ” (Polycrisis)، حيث تتشابك المخاطر البيئية مع الاضطرابات التكنولوجية والأزمات المعرفية في شبكة معقدة تُسرّع تفكك النظام الدولي. ترافق هذا التصدع بعجز متنامي للمؤسسات متعددة الأطراف التي تبدو عاجزة عن احتواء الانفلاتات المتتالية، مما يترك الساحة العالمية في حالة “سيولة استراتيجية” يبحث فيها كل فاعل عن بوصلة جديدة للاستقرار والازدهار بل للبقاء فقط.
في قلب هذه الدوامة و الفوضى التي تمس العالم بأسره، من الطبيعي أن المواطن المغربي يطرح بعض التساؤلات المشروعة:
كيف يمكن للمغرب أن يضمن الأمن والاستقرار في ظل عالم متقلب وصراعات إقليمية متصاعدة؟
إلى أي حدّ تستطيع السياسات العمومية أن تحقق العدالة الاجتماعية والكرامة للمواطن أمام البطالة وضغوط المعيشة التي أصبحت مرتبطةً بالسوق العالمية وسياسات القوى الدولية؟
وكيف يمكن الحفاظ على المعنى والهوية الوطنية (التمغربيت) في مواجهة العولمة والفوضى الرمزية في عالم رقمي بامتياز؟
ثم ما هو موقف المغرب من القضايا العالمية التي لديها انعكاسًا على وضعية المملكة؟
في الواقع، كل هذه الإرهاصات تبقى طبيعية مع تحول العالم إلى فضاء ضيق سريع الاتصال وكثيف التواصل . ففي نظر التحاليل الجيو-اقتصادية، يبرز المغرب كحالة لافتة للنظر. فموقعه عند ملتقى أوروبا وإفريقيا والأطلسي يجعله في خط المواجهة المباشر مع الصدمات العالمية، لكنه يمنحه في الوقت ذاته أوراق قوة فريدة. لقد اختار المغرب ألا يكون مجرد متفرج على هذه “الفوضى المنظمة”، بل أن يتعامل معها عبر دبلوماسية مرنة ونشطة وحكمة نابعة من تراكمات قرون من الوجود والتجربة الدبلوماسية، متخذاً بذلك لنفسه موقعاً في “عين الإعصار” الهادئة نسبياً. ومن هناك، يسعى إلى تحويل نقاط ضعفه البنيوية – كالإجهاد المائي الوجودي والبطالة الهيكلية والضغوط المتزايدة على الخدمات العمومية – إلى محفزات لبناء نموذج صمود خاص به.
ويستند هذا المسار الطموح إلى رصيد ثمين من الاستقرار المؤسساتي، وعقد اجتماعي قيد التعزيز، واستراتيجية تنويع جريئة للحلفاء تمتد من واشنطن إلى إفريقيا مروراً ببروكسل. كما يبدو جلياً أن هذه المقومات لا تجعل المغرب يطمح فقط إلى حماية نفسه، بل إلى التموضع كقطب استقرار وحلقة وصل لا غنى عنها في سلاسل القيمة العالمية التي يعاد تشكيلها، خصوصا مع الفراغ الذي تركته بعض الدول المنافسة.
غير أن هذا التموقع ليس مكسباً نهائياً، بل هو فعل توازن استراتيجي دائم بين إدارة المخاطر الداخلية واقتناص الفرص الخارجية فضلا عن إتقان تجنب دهس العمالقة التي تتصارع فيما بينها، وهو التحدي الذي سيحدد قدرة المملكة على صياغة مصيرها في عالم مضطرب وذي مصير مجهول.
ولفهم أبعاد هذا التحدي، يعتمد هذا المقال على منهجية “المصافي التحليلية ” filtres sémiotiques المتكاملة، التي تفكك المشهد عبر مستويات متراكبة: المصفاة الأولى تستعرض طبيعة الأزمات العالمية، والثانية تغوص في المعادلة الداخلية للمملكة، بينما تحلل الثالثة تموضع المغرب الدبلوماسي، ليختتم التحليل بالمصفاة الرابعة التي تقدم تركيباً استشرافياً للمسارات الممكنة، قبل تقديم بعض مقترحات مفاتيح النجاح.
المصفاة الأولى: تشريح الأزمة العالمية ذات الخلفيات المضطربة
لفهم المسار المغربي، من الضروري أولاً رسم الإطار العالمي الذي يتحرك ضمنه، وهي بيئة تتسم بعدم الاستقرار المنهجي، والمنافسة المحتدمة، والمخاطر متعددة الأبعاد والارتباك الذي تعرفه المؤسسات الدولية.
التفكك الجيوسياسي وعالم “اللا قيادة”
يشهد النظام الدولي تفككًا متسارعًا، تجلّت أبرز ملامحه مع عودة “دونالد ترامب” إلى سدة الرئاسة الأميركية مطلع عام 2025، حيث أسهمت سياساته التجارية العدوانية ونهجه الأحادي تحت شعار “أمريكا أولاً أو أمريكا 2.0 ” في إحداث اضطراب عميق داخل منظومة التحالفات التقليدية التي ألفها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وقد زاد ذلك من حدّة التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، دافعًا العالم نحو صيغة جديدة من القطبية الثنائية. ويبدو هذا الانقسام أقل حمولة أيديولوجية مقارنة بالحرب الباردة، لكنها أشد توتراً على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي. وقد تؤدي هذه الديناميكية إلى تفاقم الصراعات الكبرى: فالحرب في أوكرانيا تظل تهديدًا مركزيًا لأوروبا، وفي الشرق الأوسط، تطور الصراع الإسرائيلي-الإيراني إلى مواجهة عسكرية مفتوحة لا يعرف أحدٌ مخرجاتها وتداعياتها المستقبلية. كما تظل القارة الإفريقية، بوجود ثمانية وعشرون نزاعًا نشطًا، الساحة الأكثر تضرراً ومسرحاً رئيسياً للمنافسة بين القوى العظمى. و يقترن هذا المشهد بسباق تسلح قياسي (زيادة حسب بيانات الوكالات المختصة بنسبة 9.4% سنة 2024)، يرسم ملامح عالم متعدد الأقطاب وغير مستقر، عالم “اللا قيادة ” (G-Zero)، حيث يصبح الاستقرار رصيدًا نادرًا وثمينًا في نظر سكان الأرض.
في هذا السياق الجيوسياسي المتصدع، تظل منطقة الشرق الأوسط بؤرة توتر مركزي، حيث إن الإرث التاريخي الثقيل لا يزال يرسم ملامح الحاضر. فهذه الخلفيات التاريخية، من اتفاقيات سايكس-بيكو التي قسمت المنطقة، إلى المشروع الصهيوني الذي أعاد هندسة ديمغرافيتها طبقا لرؤية ” Theodor Herzl ثيودور هرتزل” المؤسس الفكري والسياسي للحركة الصهيونية الحديثة، الذي عرض في كتابه” دولة اليهود ” فكرة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. غير أن المشروع سرعان ما ارتبط برؤية توسعية عُرفت بـ”إسرائيل الكبرى”، الممتدة من النيل إلى الفرات، كما ورد في بعض الأدبيات الصهيونية المبكرة التي تستند بدورها إلى تصورات توراتية حول الخلاص وعودة الشعب المختار إلى أرض الميعاد. فهذا التصور لم يصبح مجرد مشروع قومي، بل تحول إلى خطة استعمارية تستند إلى الاستيطان والتهجير وإعادة هندسة المجال الديمغرافي بما يخدم التفوق الإثني والديني، وهو ما يفسر البعد التوسعي الملازم للفكر الصهيوني منذ نشأته. وهو ما يجعل أيضا العالم العربي و الإسلامي أمام ضرورة ردة الفعل، أي التصدي للمشروع التوسعي ذي البعد المسيحاني أو اليهودي-المسيحي (Messianique) مما ينذر بالحرب المقبلة في الشرق الأوسط والتي يمكن أن تمتد إلى القارات الأخرى.
وكل هذه الأحداث ليست مجرد وقائع بعيدة، بل تشكل سياقًا إقليميًا ضاغطًا على موقع المغرب واستراتيجياته الدبلوماسية. إنها تفرض عليه إدارة توازنات معقدة وتوقع تداعيات نزاعات قد تبدو جغرافياً بعيدة، لكنها في جوهرها متصلة بشبكة التحالفات والمخاطر العالمية التي تؤثر عليه بشكل مباشر.
الأزمة المعرفية: عصر”التخمة المعلوماتية” والخمول الفكري.
الأزمة متعددة الأوجه أو الأبعاد هي أزمة معرفية في جوهرها. لقد دخل العالم عصر “الضجيج” و”اقتصاد الانتباه”، حيث يتعرض الفرد لوابل معلوماتي مستمر (بمعدل 74 وحدة معلوماتية في الساعة بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي)، مما يفقده القدرة على التمييز بين الحقيقة والزيف. وتفاقم خوارزميات المنصات الرقمية هذا الوضع عبر حبس المواطنين في “قبائل رقمية” منغلقة على يقينياتها، مما يؤدي إلى تآكل الواقع المشترك وإضعاف التفكير النقدي. وعلاقة بموضوع تخمة المعلومات،. يصف المنتدى الاقتصادي العالمي المعلومات المضللة بأنها أكبر تهديد للاستقرار الاجتماعي العالمي. فهذه “التخمة المعلوماتية” (Infobésité) تولد “إرهاق اتخاذ القرار” وسلبية تجعل المواطن متفرجًا على مصيره بدلاً من أن يكون فاعلاً فيه.
الأزمة البيئية: الأنثروبوسين و”مضاعِفات التهديدات”
لقد دخلت البشرية بالكامل في عصر “الأنثروبوسين”، أو الحقبة الجيولوجية التي يصبح فيها نشاطها هو القوة المهيمنة في تشكيل البيئة. فالأرقام مفزعة: لقد تم تجاوز ست من “الحدود الكوكبية” التسع الحرجة، وتفوق بصمتنا البيئية القدرة البيولوجية للأرض بنسبة 75%. فلم يعد تغير المناخ تهديدًا مستقبليًا، بل أصبح اليوم “مضاعِفًا للتهديدات”، إذ يفاقم التوترات حول الموارد الحيوية الشحيحة (المياه والأراضي الصالحة للزراعة)، ويغذي بشكل مباشر الصراعات بين المجتمعات، خاصة في منطقة الساحل، ويطلق موجات من الهجرة القسرية.
التحول التكنولوجي و”حرب الذكاء الاصطناعي”
يفتح التسارع التكنولوجي، المتجسد في تطوير الذكاء الاصطناعي خصوصا فيما يتعلق بالنسخة التوليدية منه، سؤالًا أنطولوجيًا جوهريًا: ماذا يعني أن تكون إنسانًا حين تفكر الآلات وتقرر؟. فإلى جانب تهديد زوال ملايين الوظائف، يوسع الذكاء الاصطناعي نطاق “رأسمالية المراقبة”، حيث تصبح البيانات الشخصية مادة خام للتحكم الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، يصبح الذكاء الاصطناعي محورًا أساسيًا في العقائد العسكرية (أسراب الطائرات المسيرة، الحرب السيبرانية). وتشهد حكامة هذه التكنولوجيا نفسها “بلقنة”، حيث تقع في خضم “حرب معايير” إيديولوجية بين النهج التنظيمي للاتحاد الأوروبي (AI Act)، والليبرالية الأمريكية، ونموذج السيطرة الحكومية الصيني، وهو صراع سيحدد طبيعة العلاقة المستقبلية بين الفرد والدولة والتكنولوجيا.
أزمات إضافية: (الرأسمالية، الصحة، والمعنى)
في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والبيئية والتكنولوجية التي تهز العالم، تبرز ثلاث أزمات إضافية ترسم ملامح حاضر ومستقبل البشرية، الرأسمالية المتوحشة، الصحة العالمية، وأزمة المعنى. ورغم اختلافها، فإنها تتقاطع في تهديد استقرار المجتمعات ووضع الإنسان في مأزق وجودي غير مسبوق.
الرأسمالية المتوحشة لم تعد مجرد آلية لإنتاج الثروة، بل تحولت إلى منظومة تضخ السيولة لإنقاذ مؤسسات متداعية دون معالجة جذرية لاختلالاتها. هذا المنطق القصير الأمد يراكم الهشاشة ويجعل المجتمعات رهينة أزمات متكررة.
في مجال الصحة العالمية وبعد صدمة كوفيد-19، كان يُنتظر بناء أنظمة وقائية أكثر فعالية، لكن الاستعدادات لمواجهة “الجائحة X” ما تزال ضعيفة، فيما يتآكل رصيد الثقة بين الشعوب والسلطات الصحية. وهكذا تتحول أي جائحة جديدة إلى خطر مضاعف: صحي، اجتماعي وسياسي.
أزمة المعنى تكشف فراغاً روحياً وجودياً بعد انهيار السرديات الكبرى التي وحدت البشرية سلفا. هذا الفراغ يغذي التطرف والهويات المغلقة، ويجعل المعتقد نفسه عرضة للتأويل والتلاعب.
هذه الأزمات الثلاث ليست منفصلة، بل حلقات مترابطة في سلسلة اختلالات كبرى: فالرأسمالية تكشف حدود النموذج الاقتصادي، والصحة العالمية تبرز ضعف منظومات الوقاية، وأزمة المعنى تعكس فراغ الذات الإنسانية. وهي، بقدر ما تمثل تهديداً وجودياً، تفتح أيضاً المجال لإعادة التفكير في أسس العقد الاجتماعي والاقتصادي والروحي للعالم المعاصر.
المصفاة الثانية: المعادلة المغربية، بين الهشاشة الهيكلية والحكمة الاستراتيجية.
تعتمد قدرة المملكة على الإبحار في هذه البيئة المعادية على متانة أسسها الداخلية، التي تقدم صورة مليئة بالتناقضات.
نمو اقتصادي قوي ولكنه هش.
يسجل الاقتصاد المغربي نموًا مستقرا نسبيا، يتوقع أن يتراوح بين 3.6% و4.4% عن سنة 2025، مدفوعًا بدينامية القطاعات غير الزراعية كالخدمات السياحة والصناعة، ومحفزًا بالمشاريع الكبرى للبنية التحتية (كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030). غير أن هذا الأداء يظل مرتبطًا بشكل جوهري بالقطاع الفلاحي، الذي وإن كان يمثل 11% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يستوعب 30% من اليد العاملة. وتشكل هذه التبعية الشديدة لتساقطات المطر القابلية البنيوية للضعف الرئيسية للاقتصاد، حيث يهدد كل موسم جفاف النمو والاستقرار الاجتماعي بشكل مباشر. ويستند هذا النمو غير الفلاحي على ركائز صلبة، أبرزها نضج القطاع البنكي المغربي الذي تحول إلى فاعل قاري مؤثر بفضل توسعه في إفريقيا جنوب الصحراء، وقدرته على تمويل المشاريع الكبرى ومواكبة التحولات الاقتصادية الوطنية. وبشكل موازٍ، ورغم التحديات المرتبطة بجذب المزيد من السيولة، تمثل بورصة الدار البيضاء أداة تمويل حديثة ونافذة على دينامية الشركات الكبرى في البلاد، مما يعكس تطور النسيج الاقتصادي وقدرته على تبني آليات السوق الحديثة. هذان القطاعان يشكلان معًا العمود الفقري للاقتصاد المالي للمملكة، ويوفران له عمقًا استراتيجيًا يحد من اعتماده الكلي على القطاعات التقليدية.
العقد الاجتماعي، و السلم كرافعة للاستقرار الجيوسياسي
في مواجهة حالة عدم اليقين العالمي، تبنت الحكومة المغربية عن عمد سياسة ميزانية توسعية من خلال قانون المالية لعام 2025، عبر مشروع تأسيس الدولة الاجتماعية من خلال زيادة كبيرة في الإنفاق على القطاعات الاجتماعية كالصحة و التعليم وتعميم الحماية الاجتماعية. و هنا، لا يجب قراءة هذا الخيار كشأن داخلي صرف، بل يكتسي بعدًا استراتيجيًا كبيرًا. فمن خلال تعزيز الجبهة الداخلية وتقوية صمود الأسر، يحول المغرب تماسكه الاجتماعي إلى رأسمال استراتيجي. ففي عالم أصبحت فيه الانقسامات الاجتماعية خطرًا عالميًا، المغرب المستقر اجتماعيًا هو مغرب أقوى سياسيًا، قادر على التفاوض من موقع قوة على الساحة الدولية.
التحديات الهيكلية والاجتماعية: السباق مع الزمن
وراء الأداء الماكرو اقتصادي، فإن مسار المغرب مشروط بقدرته على التغلب على تحديات هيكلية عميقة:
أزمة المياه، تهديد وجودي: تواجه المملكة أزمة مياه غير مسبوقة، توصف بـ “التهديد الوجودي”. تكشف هذه الأزمة عن مفارقة زراعية كبرى: فقد طورت البلاد زراعات تصديرية كثيفة الاستهلاك للمياه(تستهلك 87% من الموارد) بينما تظل معتمدة على استيراد الحبوب الأساسية، مما يعادل تصدير “المياه الافتراضية” ( أي بصيغة أخرى فإن تصدير المنتجات الفلاحية، رغم وقعها على رصيد العملة الصعبة، فإنها تستنزف الموارد المائية، مما يستدعي التعجيل بحل تحلية المياه البحر عبر استثمارات ضخمة وتدبير معقلن لفواتير الطاقة، و هنا يكمن السباق مع الزمن حيث سيحدد نتيجته الأمن الغذائي والاجتماعي للبلاد.
البطالة الهيكلية: على الرغم من النمو الديناميكي، تظل البطالة مرتفعة هيكليًا، وتؤثر بشكل خاص على الشباب والنساء، مما يشكل تهديداً طويل الأمد للعقد الاجتماعي وهدراً لرأس المال البشري.
إصلاح الخدمات العمومية (الصحة والتعليم): جعلت الدولة من إصلاح هذه الخدمات أولوية، لكن التحدي هائل لضمان تعليم جيد ورعاية صحية ذات جودة في جميع أنحاء التراب الوطني.
الثقة والعدالة: يعد توطيد سيادة القانون وإصلاح العدالة تحديًا مركزيًا لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، خاصة المنتخبة.
تآكل القدرة الشرائية: أدى التضخم إلى إضعاف مستوى المعيشة، خاصة للطبقة الوسطى، مما يشكل مصدرًا لتوترات اجتماعية كامنة.
وزن الاقتصاد غير المهيكل: خلف الأرقام الرسمية، يمثل الاقتصاد غير المهيكل واقعًا اجتماعيًا واقتصاديًا معقدًا. فبينما يعمل كـ “ممتص للصدمات الاجتماعية” عبر توفير فرص عمل وبدائل اقتصادية لشريحة واسعة من السكان، مما يساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي، فإنه يشكل في الوقت ذاته عائقًا أمام التنمية الهيكلية، حيث يحد من توسيع القاعدة الضريبية ويعيق تعميم الحقوق الاجتماعية، مما يجعله تحديًا مزدوج الأبعاد.
الرأسمال البشري وهجرة الأدمغة (الكفاءات): يظل الرأسمال البشري هو المورد الأثمن والتحدي الأكبر للمغرب. ففي حين يمثل الشباب “عائداً ديمغرافياً” يمكن أن يكون محركًا للنمو، فإن ظاهرة “هجرة الأدمغة” تستنزف البلاد من أفضل كفاءاتها في قطاعات حيوية. إن الفشل في توفير الفرص الجذابة لهذه الكفاءات لا يمثل فقط هدرًا للموارد، بل يهدد القدرة التنافسية للمملكة على المدى الطويل، مما يجعل الاستثمار في الاحتفاظ بالمواهب أولوية استراتيجية قصوى.
الدور المركزي للمؤسسة الملكية:
إن مفهوم الاستقرار السياسي في المغرب يرتكز بشكل جوهري على مركزية المؤسسة الملكية. فالملكية ليست مجرد رمز تاريخي، بل هي فاعل استراتيجي ومؤسسة تحكيمية تضمن الاستمرارية وتطلق الإصلاحات الكبرى (مدونة الأسرة، الجهوية المتقدمة، الدولة الاجتماعية، المبادرة الأطلسية). يضاف إلى ذلك، رمزية “إمارة للمؤمنين”، التي تضطلع بدور روحي يشكل حصنًا ضد التطرف ويمثل رافعة للقوة الناعمة للمملكة، خاصة في إفريقيا، مما يجعلها حجر الزاوية المتين في النموذج المغربي.
إلا أن هذه الوضعية المستقرة، التي تلقى استحسانا لدى جل المغاربة الذين يضعون ثقتهم في المؤسسة الملكية على عكس منسوب الثقة والمصداقية الذي تحظى به الحكومة الحالية في نظرهم، تجد نفسها أمام رهان عسير حيث يشكل المسار الديمقراطي في المغرب أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً. فمن جهة، استطاع النظام السياسي أن يحقق قدراً من الاستقرار المؤسسي عبر تنظيم انتخابات دورية وتعددية حزبية شكلية، مما منح صورة إصلاحية أمام الخارج، خاصة لدى الشركاء الأوروبيين والأمريكيين كما أن حقوق الإنسان و حرية التعبير عرفت تحسنا ملحوظا. غير أن الواقع يكشف عن بطء في تفعيل الممارسات الديمقراطية الجوهرية: ضعف دور الأحزاب في صناعة القرار، محدودية فعالية البرلمان، واستمرار مركزية القرارات، يضاف إلى ذلك بعض الممارسات من بعض الأفراد التي تنعكس سلبا على الرأي العام كالمحسوبية و الرشوة و اقتصاد الريع و استغلال النفوذ.
في هذا السياق، تبدو الديمقراطية المغربية أقرب إلى ممارسة “مراقَبة” تضمن الاستقرار وتتفادى الفوضى، لكنها في الوقت ذاته تُبقي رهانات المشاركة الشعبية والمساءلة الحقيقية مؤجلة. هذه الازدواجية بين الشكل والإطار من جهة، والمضمون والممارسة من جهة أخرى، تطرح سؤال المستقبل: هل يتجه المغرب نحو تعميق التجربة الديمقراطية بما يعزز شرعية مؤسساته، أم سيظل أسير معادلة “الاستقرار مقابل التغيير المحدود”؟
الرأسمال اللامادي والهوية المتعددة:
تكمن إحدى أعمق نقاط قوة المغرب في “رأسماله اللامادي” وهويته المتعددة الروافد التي أقرها الدستور (عربية، أمازيغية، حسانية، إفريقية، عبرية). هذه الفسيفساء الثقافية لا تشكل فقط عامل جاذبية وقوة ناعمة، بل هي أيضًا مصدر مرونة وصمود داخلي. إن القدرة على تدبير هذا التنوع وتحويله إلى رافعة للتنمية والتماسك الاجتماعي تمثل رهانًا مستمرًا وجزءًا لا يتجزأ من الاستثناء المغربي.
الأمن الوطني كأصل استراتيجي:
يُبنى الاستقرار المغربي كذلك على فعالية استراتيجيته الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. فالمقاربة المغربية، التي تجمع بين العمليات الاستباقية والتعاون الدولي الوثيق وإصلاح الحقل الديني، قد أثبتت نجاعتها وجعلت من المملكة شريكًا لا غنى عنه للولايات المتحدة وأوروبا. هذا التفوق الأمني لم يعد مجرد أداة داخلية، بل أصبح “أصلاً استراتيجياً” يعزز مصداقية المغرب الدبلوماسية ويجذب الاستثمارات الباحثة عن بيئة آمنة.
الديناميات المجتمعية العميقة:
طموحات وتناقضات خلف الواجهة المؤسساتية والاقتصادية، يعيش المجتمع المغربي تحولات عميقة ومعقدة. فالشباب، الذي يشكل القوة الحية للبلاد، لم تعد طموحاته محصورة في البحث عن وظيفة، بل تتجه نحو المطالبة بالمشاركة السياسية، والتعبير الثقافي الحر، والاعتراف بهوياته المتعددة التي تصقلها الثقافة الرقمية العالمية. وفي موازاة ذلك، تواصل المرأة المغربية مسيرتها نحو فرض ذاتها كفاعل أساسي في التغيير، متجاوزة الإطار القانوني لتقتحم مجالات كانت حكراً على الرجال. غير أن هذه الديناميات التحديثية تصطدم بتيارات محافظة قوية، مما يخلق صدعاً اجتماعياً بين مغرب منفتح على الحداثة وآخر متشبث بالتقاليد. إن إدارة هذه “المعركة الصامتة” حول القيم والمستقبل تمثل رهاناً لا يقل أهمية عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
ومن بين أهم التحديات التي يواجهها المغرب إضافة الى المحسوبية و الزبونية المتفشية في أغلب القطاعات، يأتي الفساد وتأثيره على الثقة. فبالرغم من التقدم المحرز في إصلاح منظومة العدالة، يظل الفساد، سواء الصغير الذي يعيق حياة المواطنين اليومية أو الكبير الذي يشوه المنافسة الاقتصادية، تحديًا بنيويًا يقوض الثقة في المؤسسات. إن استمرار هذه الممارسات لا يضعف فقط مناخ الأعمال ويثبط المستثمرين الأجانب، بل يغذي أيضًا شعوراً بالإحباط لدى المواطنين ويفرغ الإصلاحات الكبرى من محتواها. وبالتالي، فإن الانتقال من خطاب محاربة الفساد إلى تطبيق صارم وفعال لمبادئ الحكامة والمساءلة يُعتبر شرطًا أساسيًا لضمان مصداقية النموذج التنموي وتحقيق أهدافه.
يبرز مثال صارخ لهذا التحدي المرتبط بالحكامة في التداخل المتزايد بين دائرة السلطة السياسية ودائرة المصالح الاقتصادية الكبرى، ألا وهو وجود شخصيات من عالم الأعمال على رأس السلطة التنفيذية. فبالرغم من مشروعيته القانونية، يغذي تقلّد مثل هذه المناصب العليا شكوكاً بنيوية ودائمة نسبياً، وذلك بسبب وجود تضارب في المصالح، مما يجعل الحدود بين القرار العمومي والمصلحة الخاصة شبه ضبابية. وعلاوة على ذلك، يثير هذا القرب من القرارات الاستراتيجية للدولة إشكالية “مخالفة استغلال المعلومات الداخلية” بشكل غير مشروع (délit d’initié)؛ فعلى سبيل المثال، فإن المعرفة المسبقة بالشروط المطلوبة للفوز بالعقود الضخمة لمشاريع تحلية مياه البحر، أو بالمواقع الجغرافية الدقيقة للمحطات الجديدة، تجعل من هؤلاء محل شبهات.
هذا فضلاً عن الاستفادة من منح الدولة فيما يخص قطعان المواشي والمواد الفلاحية، والتي قد تؤدي إلى إثراء غير مشروع عبر مضاربات في البورصة أو في السوق العقارية والطاقية، ناهيك عن العلم المسبق بالتدابير الضريبية المستقبلية، مما يهدد نزاهة الآليات المالية الوطنية وموثوقيتها.
في هذا الأفق، تبدو الانتخابات التشريعية والجماعية لعام 2026 بمثابة موعد سياسي حاسم واختبار صلابة للعقد الاجتماعي الذي تجري إعادة تشكيله. هذا الاقتراع لن يقتصر على تقييم حصيلة السلطة التنفيذية في مواجهة التحديات الاقتصادية (التضخم، التوازن بين الدخل و الأسعار) وتنفيذ الأوراش الاجتماعية الكبرى فحسب، بل سيجسد بشكل خاص مسألة الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة. وفي سياق يتسم نسبيا بانعدام الثقة تجاه الأحزاب السياسية، فإن قدرة هذه الأخيرة على تعبئة جمهور انتخابي، خاصة الشباب، الذي يتجه بشكل متزايد للعزوف، وتقديم رؤى ذات مصداقية، لن تحدد فقط الخارطة السياسية المستقبلية، بل ستحدد أيضًا مدى نجاعة المسار الديمقراطي نفسه كقناة لضبط التوترات الاجتماعية وبناء المستقبل. وعليه، ستكون نتيجة هذه الانتخابات مؤشراً رئيسياً على نضج النظام السياسي وقدرته على تحويل تطلعات المواطنين إلى سياسات عمومية ملموسة.
المصفاة الثالثة: التموضع الاستراتيجي: دبلوماسية التوازن وتعدد الاختيارات
في هذا العالم المتشظي، ينتهج المغرب دبلوماسية متعددة الاتجاهات، براغماتية، ومرنة، تهدف إلى تنويع تحالفاته لتأمين مصالحه القومية.
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: من المنطق الأستاذية إلى ضرورة “التحديث” و الندية
تدخل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول، مرحلة إعادة تعريف جوهرية. ففي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، عبّر المغرب عن رفضه لنموذج الشراكة الذي يضع الجنوب في موقع ثانوي ويحوّل التعاون معه إلى علاقات معاملاتية قصيرة المدى. في مقابل ذلك، تقترح الرباط رؤية استراتيجية ترتكز على الطموح والواقعية معًا، من أجل بناء فضاء أورومتوسطي متوازن ومستدام. هذا الموقف تم التعبير عنه بوضوح تام على لسان وزارة الشؤون الخارجية التي أكدت أن الشراكة الثنائية توجد عند مفترق طرق. وشددت الوزارة، بحضور المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون المتوسط، على أن المغرب لم يعد يريد أن يُعامل الجنوب كإطار هامشي ضمن برنامج أوروبي؛ بل كنصف ثانٍ من فضاء يجب أن يُبنى معًا. وأضافت أن هذه الرؤية، التي حددها الملك، تقوم على مبدأ الوضوح في التشخيص، والطموح في المنظور. هذا الموقف الأكثر جرأة أصبح ممكنًا بفضل توطيد المغرب لتحالفاته الأخرى، مما يمنحه رافعة تفاوضية أكبر ويفرض على الشركاء الأوروبيين الانتقال من منطق “العلاقة الغير المتكافئة” إلى شراكة ندية حقيقية.
التحالف مع الولايات المتحدة: ركيزة استراتيجية ثابتة
تشكل العلاقة مع واشنطن ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المغربية. ويمثل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه حجر الزاوية في هذا التحالف الاستراتيجي، الذي يتعزز بتعاون أمني وعسكري رفيع المستوى، يتجسد في مناورات “الأسد الإفريقي” السنوية.
القيادة الإفريقية: منهج التنمية المشتركة جنوب-جنوب
أصبح التوجه الإفريقي المحور الأكثر ديناميكية في الدبلوماسية المغربية. تتموضع المملكة كـ “قوة توازن” في القارة، مروجة لعقيدة التعاون جنوب-جنوب. تتجسد هذه الرؤية في مشاريع عملاقة مهيكِلة مثل خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب والمبادرة الأطلسية الهادفة لفك العزلة عن دول الساحل.
بيئة إقليمية معقدة ومُهيكِلة
التنافس المُهيكِل مع الجزائر: لا يمكن فهم السياسة الخارجية والدفاعية للمغرب بشكل كامل دون تحليل محور التنافس الاستراتيجي مع الجزائر. هذه “الحرب الباردة المغاربية” تتجاوز كونها مجرد تهديد ظرفي لتصبح عاملاً مُهيكِلاً يوجه سباق التسلح، ويؤثر على الدبلوماسية الاقتصادية في إفريقيا، ويحدد طبيعة التحالفات الدولية للبلدين. إن إغلاق الحدود البرية لا يمثل فقط عائقًا أمام الاندماج الإقليمي، بل هو تجسيد مادي لواقع جيوسياسي يفرض على المغرب استثمارًا مستمرًا في تعزيز تفوقه الاستراتيجي للحفاظ على توازن القوى الإقليمي.
فعلى مستوى منطقة الساحل، فالجوار مضطرب ويشكل مجالا لنفوذ قوى كبرى . إذ يمثل الفضاء الساحلي امتدادًا استراتيجيًا وعمقًا أمنيًا للمغرب، لكنه تحول إلى قوس من عدم الاستقرار يفرض تحديات وجودية. في مواجهة موجة الانقلابات العسكرية وتمدد النفوذ الروسي، يتموضع المغرب كقوة استقرار بديلة عبر مبادرات مثل “المبادرة الأطلسية”. تهدف هذه المقاربة إلى معالجة جذور الأزمة عبر التنمية المشتركة، لكنها تصطدم بواقع أمني متدهور يغذي الهجرة غير النظامية ويهدد أمن الحدود، مما يجعل من استقرار الساحل شرطًا أساسيًا لاستقرار المغرب نفسه.
وتبقى تحالفات مع الشرق إلى جانب شركائه التقليديين من قبيل رغبة المغرب نسج شبكة تحالفات استراتيجية مع فاعلين جدد. وتمثل الشراكة مع دول الخليج العربي، خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، رافعة استثمارية ودبلوماسية حاسمة لدعم المشاريع الكبرى بالمملكة. وفي موازاة ذلك، أعادت “اتفاقيات أبراهام ” تعريف المعادلة الإقليمية عبر فتح آفاق تعاون أمني وتكنولوجي واقتصادي غير مسبوق مع إسرائيل، مما يمنح المغرب وصولاً إلى قدرات متقدمة ويعزز موقعه كحلقة وصل بين إفريقيا والشرق الأوسط، خصوصا أمام التهديدات الإقليمية المستمرة و إشكالية استعادة وحدته الترابية.
المصفاة الرابعة: تركيب استراتيجي وآفاق مستقبلية
يكشف تحليل الموقع المغربي في عام 2025 عن ازدواجية جوهرية تحدد مساره المستقبلي، إذ يجتمع في آن واحد مزيج معقد من عناصر القوة والوهن، الفرص والمخاطر. فمن جهة، يملك المغرب رصيداً ثميناً يتمثل في الاستقرار السياسي والمؤسساتي، ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، إضافة إلى موقعه الجغرافي المحوري عند تقاطع أوروبا وإفريقيا والأطلسي، ما يمنحه قدرة على لعب دور الوسيط والدولة الجسر، فضلاً عن دبلوماسية مرنة ومتعددة الانحياز.
ومن جهة أخرى، يواجه البلد نقاط ضعف عميقة ترتبط بسياسة تدبير ظاهرة الإجهاد المائي، وتبعية اقتصادية قوية للمناخ والزراعة، وبطالة هيكلية مرتفعة خصوصاً في أوساط الشباب والنساء، فضلاً عن الاعتماد المستمر على الخارج في الطاقة والغذاء.
أما على مستوى الفرص، فإن إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية بفعل دينامية “القرب الصناعي” (Nearshoring) تمنح المغرب إمكانات هائلة لاستقطاب الاستثمارات، في وقت يتطلع فيه إلى تثبيت موقعه كرائد عالمي في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ومن ناحية أخرى، يظل التحول الرقمي رافعة مؤكدة للتنمية. فبعيداً عن كونه مجرد تهديد، يمثل التحول الرقمي فرصة استراتيجية كبرى للمغرب. فمن خلال منظومة الشركات الناشئة (Startups) التي تبتكر حلولاً في مجالات التكنولوجيا المالية والفلاحية والصحية، يمتلك المغرب القدرة على تحديث اقتصاده وخلق قيمة مضافة عالية. كما أن تسريع ورش الإدارة الرقمية (E-gouvernement) لا يهدف فقط إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، بل يشكل أداة فعالة لتعزيز الشفافية ومحاربة البيروقراطية. إن النجاح في تحقيق الإدماج الرقمي الشامل سيسمح للمملكة بتحويل رأسمالها البشري الشاب إلى محرك حقيقي للنمو في اقتصاد المعرفة.
تُضاف إلى ذلك أدواره المتنامية كبوابة اقتصادية لإفريقيا، والرهانات الرياضية الكبرى مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، التي يمكن أن تتحول إلى محفزات استثمارية ضخمة. لكن هذه الدينامية تقابلها تهديدات جدية، أبرزها عدم الاستقرار الجيوسياسي في محيطه الإقليمي (الساحل، الجزائر)، إضافة إلى تداعيات الحروب التجارية العالمية، وتفاقم شح المياه وتحولها إلى أزمة اجتماعية خانقة، فضلاً عن اختلال بنيوي للاقتصاد أمام تقلب أسعار المواد الأولية.
أمام هذه المعادلة المزدوجة، يبرز مساران متباينان و منطقيان يرسمان ملامح المستقبل:
-السيناريو المتفائل (المحور الأخضر والشامل: (حيث ينجح المغرب في تدبير أزمته المائية بفضل استثمارات التحلية وإدارة الموارد، ويستقطب استثمارات “القرب الصناعي”، ويصبح رائداً في مجال الهيدروجين الأخضر. النمو الناتج عن ذلك يمكّنه من تمويل نموذجه الاجتماعي، تقليص البطالة، وترسيخ مكانته كقوة إقليمية مستقرة ومزدهرة.
-السيناريو المتشائم “التورط المائي” أو فخ العطش : حيث يؤدي تفاقم العجز المائي إلى شل عجلة الاقتصاد، خاصة في القطاع الفلاحي، مما يطلق موجات من الهجرة الداخلية من الأرياف المنكوبة نحو المدن ويزيد من حدة التوترات الاجتماعية والاحتجاجات على ندرة الموارد. وفي ظل هذا الانكماش الاقتصادي والضغط الاجتماعي، تتراجع جاذبية المملكة للاستثمار، ويفقد المغرب زخمه الدبلوماسي، ويتعرض مساره التنموي للخطر، ليجد نفسه محاصراً في حلقة مفرغة من الأزمات الهيكلية.
في قلب هذا المشهد المليء بالاضطرابات المحتملة واللايقين، يمكن رسم مروحة واسعة من السيناريوهات الممكنة لمستقبل المغرب، تتراوح بين الطموح والانتكاس. فإلى جانب السيناريو المتفائل الذي يجعل من المملكة رائدًا في الطاقات المتجددة ومركزًا إقليميًا للاستقرار، والسيناريو المتشائم الذي يُحذّر من فخ العطش وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية، يبرز سيناريو ثالث أكثر تعقيدًا يقوم على الاستقرار الهش، حيث ينجح المغرب في الحفاظ على توازنه النسبي بفضل استمرارية مؤسساته وقدرته الدبلوماسية، لكنه يظل محاصرًا بهشاشة بيئية واجتماعية تهدد في أي لحظة بتحويله إلى بؤرة توتر جديدة. إن هذا السيناريو الوسيط يعكس حقيقة أن المسألة ليست مجرد اختيار بين النجاح أو الفشل، بل ممارسة مستمرة لإدارة المخاطر والبحث عن توازن دقيق داخل عالم غارق في فوضى سياسية ووجودية، حيث تصبح القدرة على التكيف المستدام هي المفتاح الوحيد للبقاء والازدهار.
وفي سياق استشراف المستقبل، لا يمكن إغفال سيناريو أكثر خطورة يتمثل في اندلاع مواجهة إقليمية مع الجارة الجزائر أو حتى مع إسبانيا، سواء نتيجة تصعيد الخلافات حول ملف الصحراء أو بسبب التوترات المرتبطة بالموارد البحرية والحدود. مثل هذا السيناريو، وإن ظلّ مستبعدًا على المدى القريب، فإنه يظل قائمًا في بيئة جيوسياسية متقلبة تُضاعف فيها الأزمات الهوياتية والضغوط الاقتصادية من احتمالات الانزلاق نحو صراع مفتوح. إن دخول المغرب في حرب إقليمية سيكون بمثابة “كسر للتوازن” الذي ظلّ يميّز استراتيجيته الدبلوماسية خلال العقود الأخيرة، وسيهدد ليس فقط استقراره الداخلي، بل أيضًا مكانته كقطب استقرار في إفريقيا والفضاء الأورومتوسطي. ومع ذلك، فإن إدراك هذا الاحتمال هو في حد ذاته دعوة ملحّة لتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز أدوات الردع الاستراتيجي بما يجعل خيار الحرب مكلفًا وغير مغرٍ لأي طرف يفكر فيه.
خاتمة: مستقبل المغرب،حكمة ملكية وفعل توازن استراتيجي
في نهاية المطاف، يخوض المغرب مع نهاية سنة 2025 ممارسة مستمرة من التوازن الاستراتيجي. إنه لا يكتفي بتحمل الفوضى العالمية، بل يحاول استغلالها لصالحه، من خلال توظيف استقراره والتموضع كحلقة وصل في اقتصاد عالمي متشظٍ. تمثل الأزمة المتعددة الأبعاد “اختبار تحمل” حقيقي لصلابة هذا النموذج، حيث إن قدرة المملكة على إدارة هشاشتها المناخية الوجودية من جهة، والاستفادة من أوراق قوتها الجيوسياسية من جهة أخرى، ستكون العامل الحاسم في نجاحها.
إن نجاح هذا التمرين المعقد لن يعتمد فقط على الظرفية الدولية، بل بالدرجة الأولى على قدرة المغرب على توطيد جبهته الداخلية. وهذا يتطلب تحولاً عميقاً في الحكامة يتجاوز مرحلة “الديمقراطية المراقَبة” نحو عقد اجتماعي متجدد قائم على الثقة والشفافية والمساءلة، بما يعزز شرعية المؤسسات ويحصّن البلاد ضد الانقسامات. وبناء على هذا الأساس المتين من الثقة و الحكامة الرشيدة، يصبح من الممكن بناء اقتصاد صامد ومبتكر. فلا يمكن مواجهة تحديات المستقبل دون الاستثمار المكثف في الرأسمال البشري، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد الخدمات عالية القيمة (التثلثTertiarisation )، وتبني الذكاء الاصطناعي كرافعة للتنافسية. إن إرساء مناطق اقتصادية متخصصة في الهيدروجين الأخضر والخدمات الرقمية ليس خياراً، بل ضرورة للانعتاق من الاعتماد المفرط على المناخ.
وفي موازاة ذلك، فإن هذا التحول الداخلي يجب أن يكون محميًا بسيادة استراتيجية ودبلوماسية حازمة. فالتعامل مع أزمة المياه باعتبارها قضية أمن قومي عبر “مخطط مارشال” حقيقي، وترجمة الريادة الدبلوماسية في إفريقيا إلى نفوذ اقتصادي عبر أدوات كالصناديق الاستثمارية، هما وجهان لعملة واحدة: تأمين مستقبل البلاد وترسيخ دورها كقوة توازن إقليمية. بهذا الثمن فقط، حيث تتكامل الحكامة الرشيدة مع الابتكار الاقتصادي والسيادة الاستراتيجية، ستتمكن المملكة من تحويل رؤيتها إلى واقع مستدام ومزدهر لمواطنيها، وإعادة تعريف دورها كوسيط وقطب استقرار في قلب عالم مضطرب يبحث عن بوصلة جديدة.






